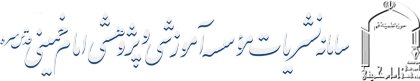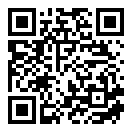ملخص المقالات
Article data in English (انگلیسی)
نوع ونطاق دور الوجود فی الحمول الماهویة من منظار العلّامة الطباطبائی
السیدأحمد الحسینی سنکشال/ ماجستیر الفلسفة من جامعة تربیت مدرس Hosseini.sangchal.ahmad@gmail.com
محمّد سعیدی مهر / أستاذ فی جامعة تربیت مدرس saeedi@modares.ac.ir
الوصول: 5 ربیع الاول 1438 ـ القبول: 20 شوال 1438
الملخص
من الأهمیة بمکان دراسة الدور الذی یؤدّیه الوجود فی الحمولات الماهویة بعد إثبات أصالة الوجود، الأمر الذی لا یقلّ شأناً من مسألة أصالة الوجود وإثباتها وهو بوجه آخر تکملة لمشروع أصالة الوجود. وأعار العلّامة الطباطبائی فی مؤلّفاته اهتماماً کبیراً بالکشف عن هذا اللغز؛ ولکن یبدو أنّ شارحی مؤلّفاته لم یضبطوا الجانب الإبداعی من هذه الاهتمامات. أمّا الباحث فی المقالة التی بین یدی القارئ الکریم، فیقوم بتوجیه النقد إلى وجهة النظر التی یؤدّی الوجود فیها دوره کجزء من الموضوع، بحیث إنّ الحملی الماهوی لا یتحقق إلّا من خلال کون الماهیة موضوعاً بقید الوجود. ومن ثمّ یدافع الباحث من وجهة النظر التی ترى أنّ الوجود تمام الموضوع. وعلیها، فإنّ المحمولات الماهویة إذا تمّ عرضها فی جملة صحیحة من الناحیة البنیویة، فتُعتبر محمولات للوجود. وفی الوقت نفسه لا یمکن الدفاع المطلق عن کون دور الوجود تمام الموضوع، وإنما یتعلّق هذا الحکم بالآثار الخارجیة للماهیة ولا یتصف الوجود بالآثار الذهنیة للماهیة.
کلمات مفتاحیة: الوجود، الحیثیة التقییدیة، المحمولات الماهویة، العلّامة الطباطبائی.
وقفة على وجهة نظر العلّامة الطباطبائی
وآیة الله جوادی الآملی فی باب الوحدة الشخصیة للوجود
عباس نیکزاد / أستاذ مشارک فی قسم المعارف الإسلامیة بجامعة بابل للعلوم الطبیة Nikzad37@yahoo.com
الوصول: 24 ذی القعده 1437 ـ القبول: 4 رمضان 1438
الملخص
یرى الفلاسفة الصدرائیون بالتشکیک فی مراتب الوجود، أو بعبارة أخرى وحدة الوجود وکثرته فی نفس الوقت. أمّا العرفاء والمتصوفة فی المقابل فیرى بالوحدة الشخصیة للوجود؛ أی یعتبرون الوجود واحداً شخصیاً وهو نفس وجود الحق عز وجلّ، کما یعتبرون غیره سبحانه وتعالى موجوداً بالوجود المستعار والمجازی ولیس الوجود الحقیقی. ویقول الحکماء بکثرة الوجود فی عین الوحدة. فدافع المرحوم السید أحمد الکربلائی عن نظریة العرفاء وفی المقابل دافع المرحوم الحاج الشیخ محمّد حسین الأصفهانی (کمبانی) عن نظریة الفلاسفة فی المراسلات التی دارت بینهما. أما العلّامة الطباطبائی فکتب رأیه فی ذیل هذه المراسلات وفی نهایة المطاف دافع عن نظریة العرفاء. ویرى أنّ برهان الحکماء فی باب التشکیک ینتج نفس ما یصل إلیه العرفاء فی مسلکهم؛ أی بعبارة أخرى أن برهان التشکیک یهدینا إلى الوحدة الشخصیة للوجود وإلى نفی الکثرة الحقیقیة. ومن جانب أخرى یعتقد آیة الله جوادی الآملی ما یعتقد العلّامة الطباطبائی ویقول: إنّ العرفان ینبنی على الوحدة الشخصیة للوجود والفلسفة تنبنی على الکثرة الحقیقیة للوجود. إنّ الوجود المحض فی العرفان هو الوجود الواحد ولا یُفترض وجودٌ آخر یستقل عنه أو یرتبط به. أمّا الأمور المقیدة والمحدودة فهی آیات واجب الوجود وعلاماته وظهوراته.
أمّا الباحث فی المقالة التی بین یدی القارئ الکریم، فیقوم بدراسة ونقد وجهات نظر العلّامة الطباطبائی وآیة الله جوادی الآملی وأدلّتهما، وفی الختام یثبت حقانیة مدرسة الحکماء.
کلمات مفتاحیة: الوحدة الشخصیة للوجود، تشکیک الوجود، العرفاء، الفلاسفة الصدرائیون، العلامة الطباطبائی، آیة الله جوادی الآملی.
دراسة ونقد استدلالات الفلاسفة لإثبات الثبات ونفی الحرکة فی المجرّدات
یحیى نورمحمّدی/ دکتوراه فی فرع الحکمة المتعالیة بمؤسسة الإمام الخمینی ره للتعلیم والبحث normohamadi2531@anjomedu.ir
الوصول: 21 ذی الحجه 1437 ـ القبول: 3 شعبان 1438
الملخص
یعتقد معظم الفلاسفة أنّ المجرّدات ثابتة وینفون الحرکة فیها، وبرهان القوّة والفعل هو أهمّ أصل وأکبر دلیل لهم فی التشبّث بهذا الرأی. ویثبت هذا البرهان أنّ القوّة من شؤون المادّة والجسم الذی یحظى بالقوّة کذلک یتمتع بالمادّة، وذلک اعتماداً على التقابل (العدم والملکة) بین الفقدان (القوّة) والوجدان (الفعل). وینفون کلّ قوّة فی المجرّدات عن طریق وساطة البساطة وفقدان مزیج من القوّة والفعل. ولمّا کانت الحرکة خروج الشیء من القوة إلى الفعل، ولا یتمکّن الموجود البسیط الذی هو لا یترکب من القوة والفعل من الحرکة، فیُثبت ثبات أو عدم إمکانیة الحرکة فی المجرّدات التی تحظى بوجود بسیط لاینفعل. ولکن یجدر هنا الانتباه إلى أنّ قید "القوّة" فی الحرکة لا یعنی ضرورةً الأمر الذی یمتدّ جذوره فی "الهیولى" المشائی (وإن جاءت القوّة فی تعریف الحرکة عند منکری الهیولى المشائی)، بل تنسجم "القوّة" أو کون الأمر "بالقوّة" مع بساطة المتحرّک وموضوع الحرکة. وعلیه فإنّه لا یمکن نفی کون المجرّدات موضوعاً للحرکة، وذلک بسبب کونها بسیطة وفاقدة للمادّة.
کلمات مفتاحیة: الثبات، الحرکة، المجرّدات، الهیولى، القوّة والفعل.
دراسة وتبیین الیقین المعرفیّ
فی المدرسة الاستقرائیة للشهید السید محمّد باقر الصدر.
محمّد محمّدرضائی / أستاذ فی قسم فلسفة الدین و الفلسفة الإسلامیة بجامعة طهران (فردیس فارابی) mmrezai391@yahoo.com
السیدة حوراء الموسوی/ ماجستیر الفلسفة والکلام الإسلامی بجامعة طهران (فردیس فارابی)
الوصول: 10 ذی الحجه 1437 ـ القبول: 24 رجب 1438
الملخص
إن علم المعرفة الصدری وجّه النقد إلى حلّ أتباع المدرسة العقلیة فی عودة الاستقراء إلى التجربة والقیاس کما ینتقد حلّ أتباع المدرسة التجریبیة ویعرّف أنّ أساسه الاستقرائی ینبنی على المدرسة الذاتیة، وبناءً على هذه المدرسة فإنّ المعرفة البشریة ستصل إلى الیقین الموضوعی ولا المنطقی فی طریق الاستقراء، وذلک بعد التصدیقات المحتملة و عن طریق التوالد الذاتی. ویمکن تفسیر الدلیل الاستقرائی للشهید الصدر بناءً على التجاوز عن مرحلتین: المرحلة الأولى هی الوصول إلى الدرجات المحتملة وتعزیزها بناءً على العلم الإجمالی حتى أعلى مرتبة من الاحتمال وهی مرحلة استنباطیة. والمرحلة الثانیة هی مرحلة التوصّل إلى الیقین عن طریق التوالد الذاتی ومراعاة شروط المنطق الذاتی. ومن المحتمل جدّاً أن تصل درجة التصدیق إلى الیقین فی المرحلة الثانیة. فیتمّ هذا التحوّل بناءً على أصل بدیهی، ومعیار صدق البداهة لهذا الأصل واختلافه عن البداهة الوهمیة هو التناسق والانسجام مع سائر الیقینیات الموضوعیة منها أصل العلم الإجمالی وأصل امتناع الترجیح بلا مرجح. وفی قسم التقییم المعرفی لوجهة نظر الشهید الصدر، ومن خلال التجنّب عن الأقوال الکلیة واتهام المدرسة الصدریة بالجنون، ونظراً لبعض الإشکالات التی یتمّ توجیهها إلى التأسیسیة المعتدلة للشهید الصدر فی المدرسة الذاتیة ولا سیّما معیار الصدق الذی یسوقه إلى النزعة الإنسجامیة، فیبدو أنّ علم المعرفة الصدری على الرغم من نجاحه فی تبیین المرتبة التصدیقیة المحتملة وکذلک الاعتقاد بدخالة الموضوع فی التصدیق؛ ولکن لم یحالفه التوفیق فی واقعیة الیقین الموضوعی وثمّة إشکالات أساسیة موجّهة إلیه.
کلمات مفتاحیة: الیقین الموضوعی، الاستقراء، التوالد الذاتی، التأسیسیة المعتدلة.
تحلیل انتقادی لوجهة نظر دیفید هیوم حول الجوهریة وهوهویة الذهن
محمد تقی یوسفی / أستاذ مساعد بجامعة باقر العلوم علیه السلام Yosofi@bou.ac.ir
میثم شادبور / طالب دکتوراه فی فرع الفلسفة الإسلامیة بجامعة باقرالعلوم علیه السلام shadpoor6348@gmail.com
الوصول: 22 صفر 1438 ـ القبول: 12 ذی الحجه 1438
الملخص
ترک هیوم من خلال اتجاهه التجریبی بصماته جلیاً على الفلسفة الحدیثة، ویقوم فی اوّل وأهم کتبه الفلسفیة المسمّى بـ"رسالة فی الطبیعة البشریة" بتبیین الجوهریة وهوهویة الذهن والأحوال الذهنیة. أمّا الباحثان فی المقالة التی بین یدی القارئ الکریم، فیقومان بدراسة ونقد رؤیة هیوم من خلال الاعتماد على المنهج التحلیلی الانتقادی. ویرى هیوم فی موقف سلبی أنّه لا انطباع لجوهریة الذهن وهویته وبساطته الکاملة وبالتالی أنها لا فکرة لها ولا معنى، وذلک استناداً إلى بعض المبانی والأسس المبهمة والمشوّهة؛ ولکنه یدافع فی موقفه الإیجابی عن الجوهریة والهویة الناقصة للأحوال الذهنیة، وفی نهایة المطاف فیحکم برجحان التشکیک بسبب التناقضات الموجودة فی موقفه الإیجابی. إنّ التشکیک فی فلسفة هیوم یعنی فقدان الشرح المتافیزیقی المناسب بالنسبة إلى المعتقدات الطبیعیة ولیس فقدان نفس المعتقدات الطبیعیة. والإشکالیة الأساسیة التی یعانی منها تبیین هیوم هی الغفلة عن العلم الحضوری ودور العقل فی التنبّه إلیه. ویبدو أنه یمکن تقدیم تبیین أفضل وأکثر إقناعاً من جوهریة النفس واختلافها عن الظواهر والحالات النفسانیة، وذلک من خلال الاعتماد على العلم الحضوری، وعلیه فإنّ ثمّة جوهر یطلق علیه اسم النفس وتقوم علیها الحالات النفسانیة.
کلمات مفتاحیة: الذهن، الأحوال الذهنیة، الجوهر، الهویة الشخصیة، هیوم.
مقاربة مقارنة نحو مادیّة النفس فی الکلام الإسلامی والفیزیائیة فی فلسفة الذهن
مصطفى عزیزی علویجه / أستاذ مساعد فی قسم الفلسفة بجامعة المصطفى العالمیة M.azizi56@ yahoo.com
الوصول: 16 ذی القعده 1437 ـ القبول: 25 شعبان 1438
الملخص
ثمّة رؤیة رائجة بین المتکلمین الإسلامیین بمختلف اتجاهاتهم من الأشاعرة، والمعتزلة، وأهل الحدیث وبعض المتکلمین الإمامیة وهی أنّهم یفسّرون النفس تفسیراً جسمانیاً ومادیّاً. ویعتقد أتباع بعض هذه الاتجاهات الکلامیة أنّ النفس جسم لطیف، والبعض الآخر أنّها جزء أساسی من الجسم، والبعض الآخر أنّها عرض، کما ینکر البعض الآخر وجود النفس أساساً ویرون أنها هی الجسم والهیکل المحسوس. وثمّة اتجاهات فیزیائیة مختلفة فی مجال فلسفة الذهن التی تسلّموا نفس الإنسان أو ذهنه إلى الدماغ أو الوظیفة أو السلوک. ویطلق على هذه الاتجاهات اسم "هویة الذهن والدماغ"، و"الوظائفیة"، و"المدرسة السلوکیة". أما الباحث فی المقالة التی بین یدی القارئ الکریم، فیقوم بالبحث فی مبانی والبنى التحتیة لهذه الرؤى والاتجاهات واستخرج النتائج والمستلزمات المشترکة بینها کالهویة الشخصیة، وحقیقة الموت، والحیاة البرزخیة، والآثار المذهلة للنفس، والکرامة الإنسانیة، وذلک بعد تبیین وجهات النظر المتعلّقة بمادیّة النفس فی الکلام الإسلامی ومقارنتها الإجمالیة مع النظریات الفیزیائیة فی فلسفة الذهن.
کلمات مفتاحیة: النفس، الذهن، الجسم، المادیة، الفیزیائیة.
نظرة على عدم إمکانیة بیان التجارب العرفانیة
مرتضى رضایی / أستاذ مساعد فی قسم الفلسفة بمؤسسة الإمام الخمینی ره للتعلیم والبحث arezaee4@gmail.com
الوصول: 28 ربیع الاول 1438 ـ القبول: 14 محرم 1439
الملخص
أکّد الکثیر من العرفاء والفلاسفة من شرق المعمورة وغربها عدم إمکانیة بیان ووصف التجارب العرفانیة. وثمّة أدلّة طرحت حول السرّ الکامن فی عدم إمکانیة وصف حالات العرفاء وکیفیتها وماهیّتها. وکون التجارب العرفانیة غیر قابلة للوصف یستلزم أن یکون کلام العرفاء خالیاً من المعنى والمضمون، وأن یکون فاقداً للقیمة والاعتبار من الناحیة الواقعیة؛ ولکن هل یمکن أن نکون ملزماً بمثل هذه المستلزمات؟ ولقد قدّم العرفاء وغیرهم بعض المبررات والتفاسیر لتبریر قیمة بیانات العرفاء ولمعنى ومقصود کلامهم وسلوکیاتهم. ونظریة دیونیسیوس، ونظریة الاستعارة، ونظریة ایستس هی نظریات ثلاثة تمّ عرضها حول هذا الموضوع؛ ولکن ثمة نقاط ضعف موجّهة إلى کلّ من هذه النظریات والتی تحول دون قبولها. أمّا النظریة التی تقترحها هذه المقالة هی نظریة أخرى تبحث عن السرّ الکامن فی عدم إمکانیة بیان التجارب العرفانیة ووصفها فی بعض العوامل الخاصّة والمحدّدة، وتسعى أن تقدّم شرحاً یفقد نقاط الضعف فی النظریات الثلاثة المذکورة.
کلمات مفتاحیة: التجارب العرفانیة، عدم إمکانیة البیان أو الوصف، نظریة دیونیسیوس، نظریة الاستعارة، ونظریة ایستس.
دراسة فی الثورة الکوبرنیکیة لکانط
أحمد سعیدی / أستاذ مساعد فی مؤسسة الإمام الخمینی ره للتعلیم والبحث ahmadsaeidi67@yahoo.com
الوصول: 5 ربیع الاول 1438 ـ القبول: 23 ذی القعده 1438
الملخص
یقترح کانط للإجابة عن إشکالیات الشکاکین والمثالیین إطلاق ثورة کوبرنیکیة، والسعى وراء معرفة حقیقیّة متکوّنة متناسقة مع ذهننا والقوى الإدراکیة عندنا، بدلاً من أن نکون وراء معرفة مطابقة للعالم الحقیقی (عالم العین). ویدّعی أنّ السعی وراء المعرفة الحقیقیة التی تخطر إلى الذهن وتصبح ذهنیةً هو الطریق الوحید للهروب من الشکاکیة والمثالیة. وبعبارة أخرى نکتفی بمعرفة العالم المتکوّن فی ذهننا (العین الذهنی) ونعتبر التصور الذهنی للشـیء بمثابة نفس الشـیء (نفس الحقیقة). وکان یظن کانط أنّ الإنسان إذا سعى وراء معرفة "الحقیقة المتکوّنة فی قواه الإدراکیة" بدلاً من "الحقیقة المستقلة عنه"، فإنّ ذلک یکفل کون إدراکاته یقینیة، وبهذا الطریق سیُردّ على إشکالیات أمثال بارکلی ودیفید هیوم ردّاً مناسباً. أمّا الباحث فی المقالة التی بین یدی القارئ الکریم، فیسلّط الضوء على أنّ فلسفة کانط على الرغم من الجهود الکبیرة والجدیرة بالثناء التی بذلها؛ ولکن لم تنجح فی الردّ على الشبهات المذکورة. وبعبارة أخرى أصبحت فلسفته نسخة أخرى من الشکاکیة ویؤدّی أخیراً من الناحیة المنطقیة إلى المثالیة.
کلمات مفتاحیة: کانط، الفلسفة، العین، الذهن، الشکاکیة، المثالیّة.